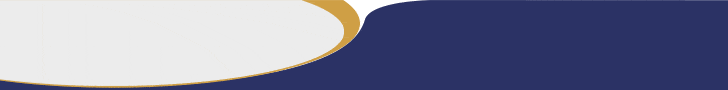اقتصادي – خاص:
تناول مقال نشره موقع “الميادين” للكاتب زياد غضن، قضية الديون الخارجية على سوريا، مشيداً بانخفاض حجم تلك الديون رغم سنوات الحرب الطويلة، ومقارناً إياها بالدول العربية التي لم تتعرض لحرب مشابهة، إلا أن المقال يشوبه عدة مغالطات تتعلق بعدم إمكانية تقديم بيانات دقيقة حول طبيعة وكلفة الاتفاقات التي أبرمها النظام مع حلفائه من أجل دعم بقاءه في السلطة، إضافة لفرادة الحالة السورية والتي تجعل مقارنتها بغيرها من دول، خطأ جسيم.
وجاء في المقال الذي حمل عنوان “رسمياً سوريا غير قلقة: المديونيّة الخارجيّة تعود من بوابة الحرب”، إنه رغم سنوات حربها الطويلة، فإنَّ سوريا لا تزال، بحسب التصريحات الرسمية، من بين الدول ذات المديونية الخارجية المقبولة، بالنظر إلى ما تعرضت له قاعدتها الإنتاجية من تخريب وتدمير كبيرين.
وهنا يجب التوضيح بأن أزمة المديونية بسوريا لم تنشأ نتيجة محاولة تغطية احتياجات اقتصادية انما هي تسديد ثمن اتفاق عسكري، ونتيجة أن العمل عسكري كان رداً على ثورة شعبية ودخلت في إطار مفاوضات دولية، مما يجعل تحصيل هذه الديون أمراً صعباً، لذا دخلت هذه الديون في مرحلة السداد عبر الاستحواذ على نشاطات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية، ورغم ذلك، حتى الآن لا يوجد بنود واضحة لمعرفة طبيعة الاتفاق وحجمه، انما يعتمد فقط على تسريبات من الطرف الدائن لا أكثر كما هو الحال مع ايران … لذا هذه الديون ستبقى كبيرة تبتز السوريين مالم يتم طرحها بشكل دولي للوقوف عندها ووضع آلية للتفاوض أو إلغائها.
واعتمد المقال على البيانات المنشورة عن صندوق النقد العربي لسرد مقارنة بسيطة بين تطور حجم الدين الخارجي لعدد من الدول العربية بين العامين 2011 و2019، يظهر أنَّ سوريا لا تزال تحافظ على دين خارجي يعتبر رسمياً مضبوطاً ومحدوداً، رغم عدم تواجد مكاتب لأعضاء صندوق النقد العربي منذ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بشهر نوفمبر من عام ٢٠١١ ، إضافة إلى أن مقارنة الدين السوري بالديون العربية غير مهني، لأن الحالة السورية حالة فريدة فالثورة السورية، غدت حرباً دولية بالوكالة والمساعدات الدولية كانت توجه لتغذية هذا الصراع.
واعتبر الكاتب في مقاله إنَّ الخطوط الائتمانية التي حصلت عليها سوريا من إيران وروسيا طيلة سنوات الحرب خصصت لتأمين احتياجات البلاد من سلع غذائية ومشتقات نفطية، وهو أمر لا يمكن تحميل مسؤوليته فقط للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، إذ إنَّ خروج حقول النفط والقمح عن سيطرة الحكومة منذ العام 2013، وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع، شكلا عاملي ضغط على إمكانيات البلاد وقدراتها على مواجهة تداعيات الحرب المتسارعة، في حين الحقيقة أن النظام هو من سلم تلك المقدرات ودعم قوات ypg التي شكلت العمود الفقري للإدارة الذاتية، وسلم حقول النفط وصوامع القمح لتشكيل نقمة من الشركات ودولها على الثورة، بل أنه قام ببيع أجزاء من تلك الصوامع وأعطى حقولاً بكاملها لكسب أمراء حرب في حربه على الثورة.
بالمقابل لا يمكن تجاهل أن الديون عبر الخطوط الائتمانية وإن كانت ببنودها تنص على تأمين السلع، إلا أنها اقتصرت على النفط وبعض السلع الضرورية التي تم بيعها للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى استخدمت من قبل النظام ومؤسساته لتمويل آلته العسكرية على حساب تلبية الاحتياجات التي خصصت لها.
وذكر المقال إن العزلة السياسية والاقتصادية التي حاول الغرب فرضها على سوريا أسهمت، إلى جانب التوجس أو الحذر السوري من مسألة الاقتراض الخارجي، في إبقاء حجم الدين الخارجي للبلاد ضمن حدود معينة، لكنَّ التحدي القادم يتمثل بقدرة الحكومة السورية على الاستمرار في ضبط هذا الدين.
إلا أن الحديث عن ضبط الدين أمر غير منطقي كونها كلمة فضفاضة، فقد انتقلت كل مؤسسات الدولة السيادية إلى صالح الحلفاء وما بقي منها، يعتبر غير مجدي من جهة، ويحتاج إلى تغييرات بالدستور، وأي إجراء لتغيير في الدستور سيفتح الباب لجعل تلك التغييرات لصالح المعارضة المدعومة من المجتمع الدولي.
إن لسان الواقع يقول بأن الحاجة للاستدانة من أجل إنقاذ الدولة السورية من الانهيار، بات مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، إلا أن الصعوبة تكمن بوجود مؤسسات تقبل تمويل النظام، بعد أن بات حال سوريا مشابهاً للحال اللبناني، خاصة وأن ما تبقى من موارد الدولة السورية، لا يمكن التصرف به، كونها تحت سيطرة “قسد” وقوات التحالف، فضلاً عن الحاجة لصيانتها وما يستغرقه ذلك من وقت قبل أن تعود للعمل، وهذا يفرض مجدداً الحاجة للاقتراض لتوفير الأموال، إضافة لحجم الخسارة في الاقتصاد والتي تدل عليها نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحجم الخسارة في القوى والطاقات الوطنية، دون أن ننسى الديون الداخلية المتمثلة بحجم الدمار في البنى التحتية والذي خلفته سنوات طويلة من الصراع على امتداد الجغرافية السورية.
إن مسألة الديون وآلية التعاطي منها تعتبر أمراً بالغ الأهمية وأمر سيادي، كما أنه سينعكس على الحياة السياسية وشكل النظام وحتى إعادة الإعمار.